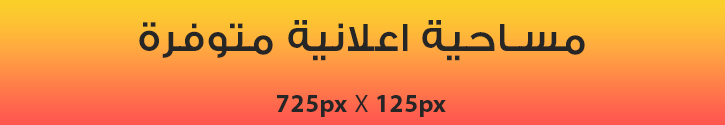سام الغُباري
أتطلع إلى نفسي وأرتعد.. كان ينبغي أن احتفل بعيد مولدي الرابع والأربعين، غير أني علقت في متابعة عزاء ضرب الحياة العامة في إيران، مع بروز توكيدات إعلامية تتهم ابن خامنئي بتدبير حادث الطائرة الرئاسية الضائعة، هوى الرئيس الإيراني “ابراهيم رئيسي” ومرافقوه مثل حجر من مسافة 2500 متر بداخل طائرة متهالكة قُدِّمت له كتابوت متنقل أودى به إلى الحرق الناري البشع، كان هذا الرئيس الذي يصفه الإيرانيين بـ السفاح ضحية ولعه الدموي في قذف المعارضين السياسيين من أبواب الطائرات.
حاول “ابراهيم رئيسي” الصعود على جبال ضخمة من جماجم الأبرياء نحو منصب الولي الفقيه إلا أن “مُجتبى” نجل خامنئي كمن له قبل نهاية المشوار، وتركه في أحراش الغابة الغائبة يحترق بهدوء !
إعتلال نظام الكهانة الإيراني وصل حد الصراع الحاد، بعد أن نثر الدماء على طول القارة الإسلامية والعربية، ففي اليمن ظل هذا النظام حريصًا على رعاية أخطر التشكيلات المذهبية ودعم الإرهابي “حسين طباطبا الحوثي” الذي تلقى دعمًا بالمال والسلاح مقابل ترديد قسم الولاء لـ المرشد الراحل “موسوي خميني”، وخليفته من بعده، وكذلك فعل شقيقه الشقيّ “عبدالملك” لتسكن الزيدية قلب النظرية الإيرانية وتدور في فلكها، متسقة مع الهوية الأم بـ طهران.
في اليوم الذي تلى هذا النهاية المقذوفة من أعلى، إرتقى رجل نقي السريرة من اليمن إلى ربه، صاعدًا نحو السماوات العُلى ، وما بين سقوط ابراهيم رئيسي، وصعود الحاج أحمد الهجري يبرز السؤال الفلسفي عن جدوى العنف في عالم محكوم عليه بالموت.
التقطت هاتفي فور سماعي نبأ وفاة هذا الرجل الطيب، نقرت على الشاشة، وانتظرت، جاءني صوت ابنه الأستاذ: عبدالرزاق الهجري – مستشار رئيس الجمهورية – مجروحًا من الداخل. هؤلاء هم ضحايا العنف الإيراني الذي كان “ابراهيم رئيسي” أحد أعمدته منذ عقود. متأسفًا على ابتعاده عن حضن والده الأخير، رأيته من وراء العبارات يمسح دموعه، ثم ينظر إلى الفراغ مبتسمًا لقولي: أن والده الآن في الجنة مع الملائكة، يمشون تحت أشجار مُزهرة، ويضحكون لغبائنا وحزننا عليهم. وسألته: أين ومتى يكون العزاء، وذهبت إلى هناك.
ازدحمت القاعة بالمعزين، وفي الخارج كان “سلطان البركاني” رئيس مجلس النواب مُغادرًا على سيارة سوداء، حزينًا ومنشغلًا بحديث مع النائب البرلماني المبتسم علي حسين العنسي، صافحته، غير أنه لم يكترث !، فمضيت في طريقي إلى قلب الصالة، صافحت كثيرًا من الشخصيات الإعلامية والسياسية، كانوا يأتون سُراعًا، ويمضون، بعضهم وجدها فرصة للقاء أصدقاءً باعدت بينهم المواقف والأماكن والحيوات المتشابكة، فبقي هناك يترقب روحًا جميلة، مناضلة، يأنس برفقتها لتعيد صقل حياته بالقوة والتفاؤل والنصر.
على بُعد خطوات كان الأستاذ عبدالرزاق الهجري يتحدث إلى معالي وزير الخارجية د. شايع الزنداني، ولمّا شعر باقترابي الضخم، وخطاي المثقلة بالضجيج، تبسّم، ونهض مُصافحًا، همست في أذنه بكلمات لطيفة مكرورة تُقال عادة في واجب العزاء، فيما لمعان الكاميرات المصاحبة يصدر صوته الخشن كأنه زعق أنثى غراب أسود.
على الجوار يسارًا كان الطيب المحترم الأستاذ أحمد القميري، داعيًا بألفة قلب صادق، وابتسامة منفرجة مرحة، ومعه يبدو الصديق العزيز عبدالسلام الحاج أكثر رشاقة من قبل، يبتسم من عينيه الواسعتين، يسبر أغوارك، ولا يدعك دون محبة ووعد بلقاء خاص، وفي الجوار الأيمن جلس الأستاذ عبدالوهاب الآنسي أطال الله عمره مُعاتبًا غيابي عنه، وضاحكًا بتؤودة، ضاعفت خجلي، وقد تمتمت له بكلمات لا أذكرها، إلا أنها كانت – على ما يبدو – من قبيل الإعتذار والتقصير من جانبي، وإليه صافحنا الأستاذ المناضل محمد اليدومي، وهو على رصانته المعهودة وصوته الخفيض يحييك ولا يتركك دون امتلاء الإحترام المتبادل.
جلست هنا وهناك، ذهبت نحو الأصدقاء الذين ابتعدوا، أو أُبعِدوا، ووجدتها سانحة في الحديث إليهم، واستعادة أيام ولّت، وأماني في كنف الله عزوجل،، وفي وسط المكان برز “خليل العُمري” الصحافي العائد من هولندا مُهذبًا كعادته، رغم حِدة بعض مواقفه، إلا أن طيبته تغفر لي حظري المتكرر له على وسائل التواصل الإجتماعي، وذلك “محمد الحُميدي” الرفيق الأكثر نشاطًا، يدور مثل نحلة، و “عمار الأضرعي” بطل كل المناسبات واللقاءات، الرجل الذي لا يمكن أن يفوته واجب، ليملئه بحضوره، وعلى جانب الممر المزدان بمقاعد مُذهبة، جلس إخوة أحبة، ورفاق عظماء، كُلهم فقدوا وطنهم، أُخرِجوا منه بغير حق، وهم في “الرياض المنوّرة” عند “محمد” قائدًا عظيمًا للعروبة، والهوية، والإصرار الذكي لبلوغ الهدف، هدف السلام والإستقرار والنماء لكل أوطاننا العربية.
ما بين سقوط “ابراهيم رئيسي” المشين، وعلو الحاج “أحمد الهجري” المبارك، اجتمعت أحاديثنا، وتلاقت أرواحنا المتآلفة على مصير يمن واحد، فيما يُذكرني هاتفي بإصرار أنه عيد مولدي، حتى خرجت من القاعة المضاءة، وبدوت كأنني أتلاشى، توهج وجهي، وكأن الضوء كله يعانقه، رميت برأسي إلى الوراء على مقعد السيارة، ، أتذكر أن شعري القصير قد تحلل بغتة وارتمى على كتفي حتى وصل إلى ذراعي، وبدأت أشدو، رددوا معي: رددي أيتها الدنيا نشيدي.. ردديه وأعيدي وأعيدي .. والله أكبر .